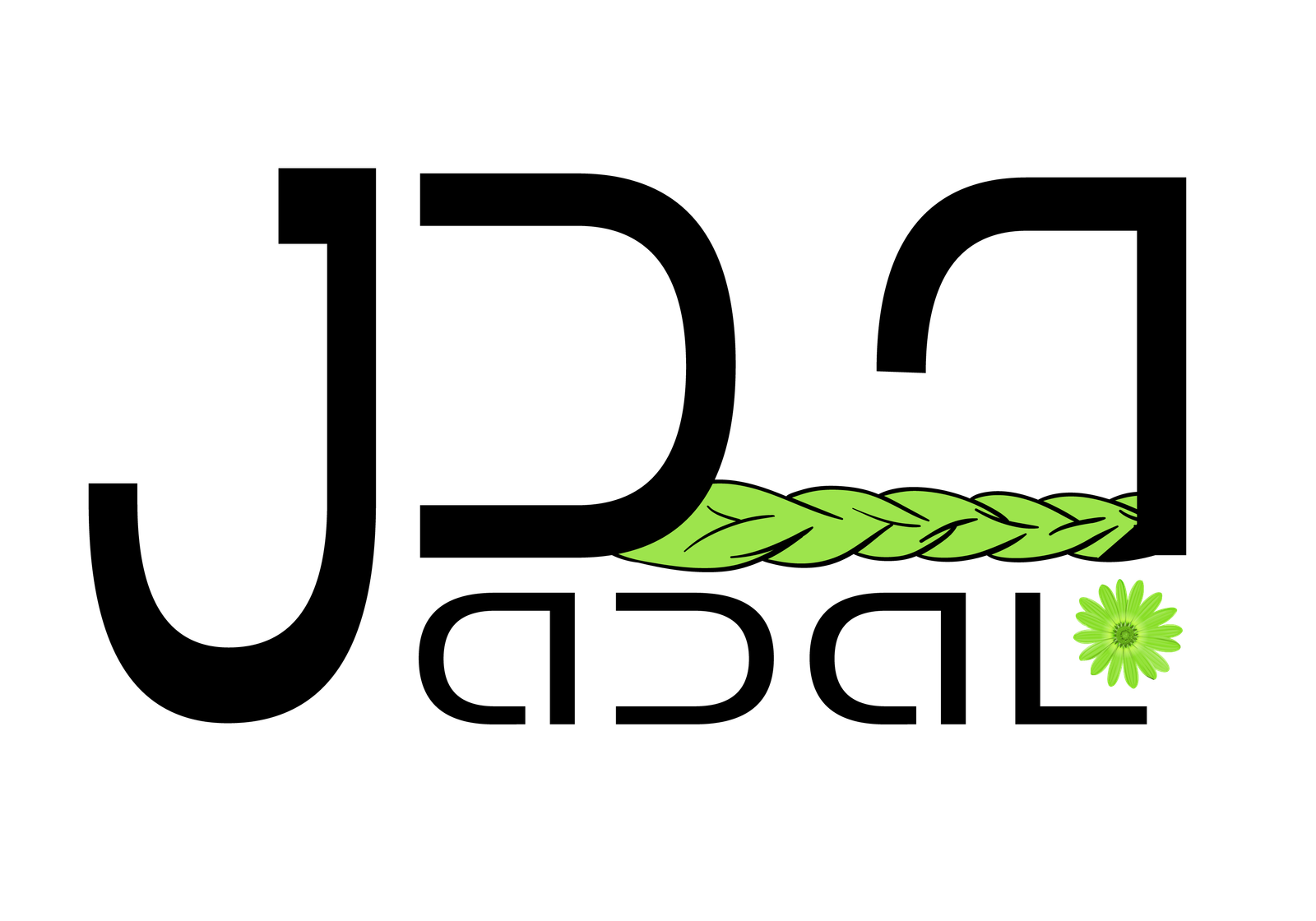في سوريا، لم يعد الحزن خبراً استثنائيّاً، ولم يعد الفقد حدثاً يثير الدهشة. صار الحداد طقساً يوميّاً، وأصبحت المقابر أكبر شاهد على حجم الكارثة. في كلّ بيت تقريباً، فقدت أسرةٌ ابناً أو أخاً أو أباً، وكلّ أمٍّ تقريباً تحوّلت إلى أرملة حرب أو أمٍّ ثكلى. لكن أكثر المشاهد قسوة ليست في ساحات المعارك، بل في عيون النساء اللواتي جفّت دموعهن من فرط الفقدان. في سوريا، لم يعد السؤال: “في أيّ صف كان؟” بل صار: “كيف مات؟”، و”لماذا لم يعد؟”.
الوجع الذي يوحّد الأمهات
الأمّ السوريّة التي فقدت ابنها وهو يقاتل في صفوف الأمن، ثمّ أُبلغت بموته بعد سنوات من الخوف والترقّب، لا تختلف عن تلك التي تلقّت نبأ مقتل ابنها وهو يحارب ضدّ النظام. ولا تختلف عن الأمّ التي رأت ابنها مسجّى في الشوارع، منزوع الملامح، ممزق الجسد.
لا فرق بين أمٍّ تلقّت ابنها في تابوت مختوم، وأخرى لم تجد حتّى ما تدفنه. هؤلاء الأمّهات لم يحملن السلاح، لم يقررن الحرب، لم يخترن المعسكرات، لكنّهن دفعن أغلى ثمن يمكن أن يُدفع: فلذات أكبادهن.

تسييس المأساة وسرقة الحزن
نعيش في وطن، يُسلب الحزن من أصحابه. إذ صارت دموع الأمّهات جزءاً من السجال السياسي، وأصبح الحداد ذاته تهمة. صور الأمّهات المفجوعات تُسرق، وتُحرف، وتُستخدم في الصراع الإعلامي، وكأنّ هذه النساء لم تفقد أبناءهن، بل مجرّد قطع شطرنج في لعبة لا ترحم.
الأمّ التي وقفت بين جثث أبنائها، بينما القتلة يهينونها بطائفيّة مقززة، لم تكن تفكر في الجهة التي رفعوا علمها، بل كانت تبحث عن ملامح أحبّائها وسط الدم والتراب. والأمّ التي أصرت على فتح التابوت، رغم محاولات من حولها منعها، لم تكن تريد تحدّي السلطة، بل فقط أن تطبع قبلة أخيرة على جبين ابنتها التي لم تتعرّف عليها.
في لحظة الفاجعة، لا يوجد طرف يستحقّ التصفيق. لا يوجد بطل، ولا شهيد أنقى من شهيد، ولا قضيّة أطهر من أخرى. هناك فقط أمّهات تُنتزع أرواحهن مع كلّ رصاصة، مع كلّ مقطع فيديو يوثّق الجريمة، مع كلّ تابوت يُمنع من الفتح حتّى لا تُرى الحقيقة.

وحشيّة الحرب وانهيار القيم
لم تكن الحرب السوريّة عبارة عن نزاع مسلح، إنما انحدار إلى هوّة سحيقة من البشاعة. والكارثة الحقيقيّة لم تكن القتل فحسب، بل الطريقة التي تحوّل فيها بعض البشر إلى وحوش، وكيف فقدوا الحدّ الأدنى من الإنسانيّة. كالتمثيل بالجثث، وإذلال الموتى، وتصفية الأسرى، وإطلاق الرصاص على جسد ميّت وكأنّه لم يمت بما يكفي.
أيّ حقد يجعل إنساناً يفرغ ثلاثين رصاصة في قدمي فتاة لا تحمل سلاحاً؟ أيّ وحشيّة تجعل مجموعة من القتلة يسحلون جسداً بلا روح، ويضحكون؟ كيف أصبح الموت نفسه أقلّ قسوة من الطريقة التي يُقتل بها السوريون؟ هذه ليست حرباً، ولا قتالاً، ولا معركة وطنيّة، بل هو مشهد من الجحيم ذاته.
العدالة لا الانتقام
ما تحتاجه سوريا ليس مزيداً من الدماء، ولا مزيداً من الأمّهات المفجوعات، وإنّما تحتاج إلى الكثير من الناجين القادرين على قول الحقيقة دون خوف، ومن الذين لا يبررون الجريمة بحجة أنّها جاءت من “طرفنا”.
المشكلة ليست في أنّ هناك مجرمين، بل بوجود من يبرر لهم. فهناك من يغطّي وجوه القتلة بأعلام، وثمّة من يغسل أيديهم بالخطابات الطنّانة.

كلّ قاتل في هذه الحرب مجرم، كلّ من ذبح ومثّل بجثّة، كلّ من قتل إنساناً أعزل، لا يمكنه أن يكون بطلاً، ولا يمكن أن يُمنح شرف الدفاع عن أيّ قضيّة. لكن المشكلة الأكبر أنّ هذه الحرب علّمتنا القسوة، علّمتنا الصمت، علّمتنا أنّ الحزن يجب أن يكون انتقائيّاً. أصبح البعض يواسي أمّاً ويبصق على أخرى، يعترف بوجع ضحيّة وينكر وجعاً مماثلاً، كما لو أنّ الفقد يمكن أن يكون أقلّ حدّة بناءً على هويّة القاتل.
لا وطن يُبنى فوق الجماجم. ولا عدالة تُصنع بإنكار نصف الجرائم. ولا مستقبل لهذا البلد إن لم نحاسب كلّ المجرمين، بغضّ النظر عن الراية التي رفعوها وهم يطلقون الرصاص.
إن كان هناك شيء واحد يستحق أن نقاتل من أجله اليوم، فهو ألا يكون هناك جيل جديد من الأمّهات المفجوعات. وكم أتمنّى ألا نكون قد تأخرنا!