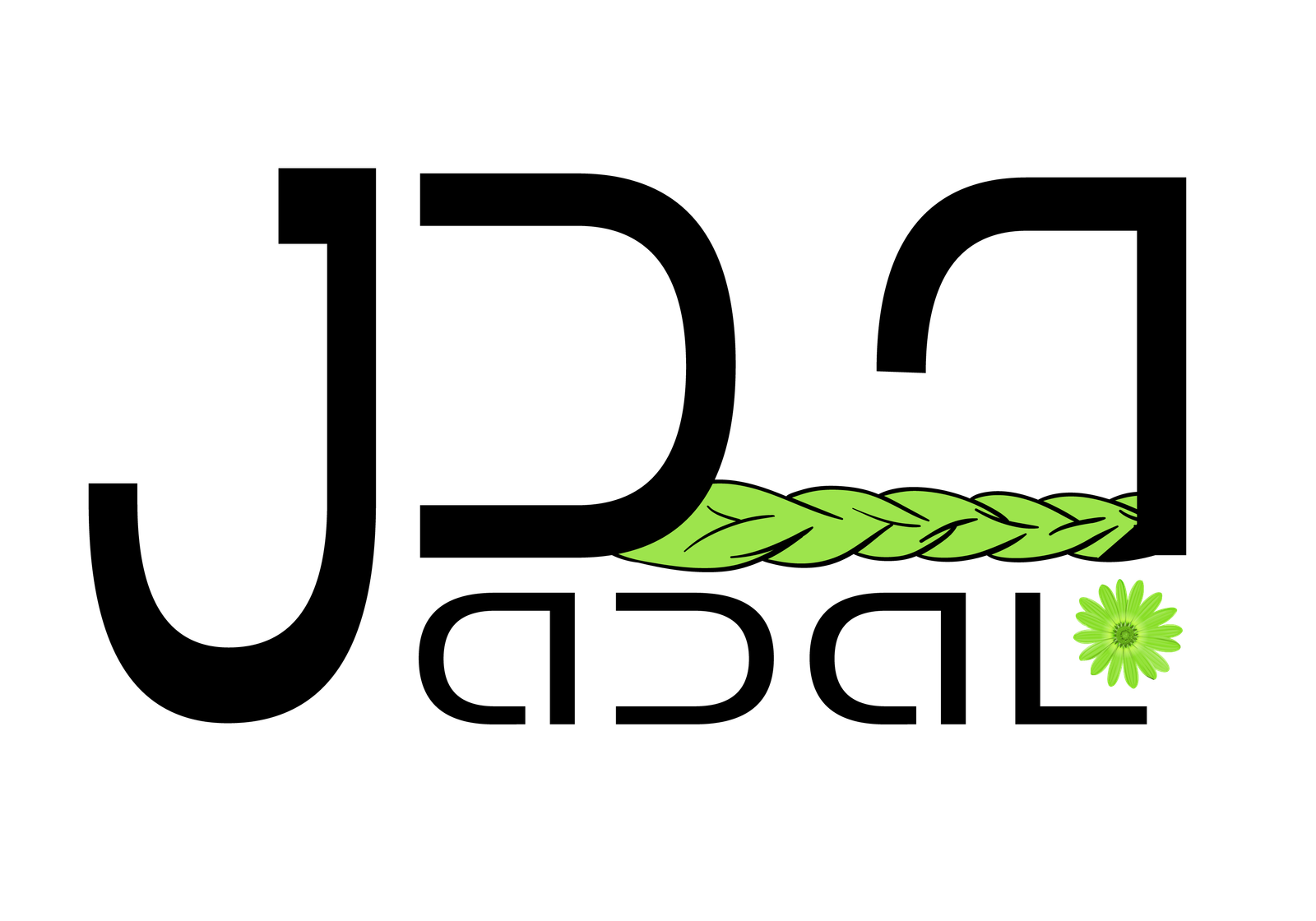يأتي غيث حمّور كأحد أبرز كتّاب المنفى السوريين الذين جعلوا من السرد أداةً لكشف تشوّهات الواقع وتعرية البُنى العميقة للسلطة والمجتمع. في رواياته “أبيض قان”
و”فسادستان” و”غراب” و”صنمان” و”إمبراطورية” ومجموعاته القصصيّة المتعدّدة، يقدّم حمّور أدباً يزاوج بين النقد والسخرية والخيال، محاولاً فهم الإنسان السوري في
لحظته الأكثر تعقيداً. في هذا الحوار، نقترب من رؤيته الإبداعيّة، ونسأل عن أثر المنفى، وعن موقع الكتابة في مواجهة ما يحدث في سوريا اليوم.
الكاتب والروائي غيث حمّور في حوار خاصّ لـجدل نيوز
-تشتغل رواياتك على تفكيك البُنى السياسيّة والاجتماعيّة في سوريا، كما في “فسادستان” و”صنمان”. كيف توازن بين الكتابة الأدبيّة والطرح السياسي النقدي دون أن يطغى أحدهما على الآخر؟
في “فسادستان” و”صنمان” وغيرهما، لا أتعامل مع السياسة باعتبارها هدفاً مباشراً، بل بوصفها طبقة لا يمكن فصلها عن التجربة السوريّة. الواقع نفسه مُسيَّس إلى حدّ أن تجاهله يصبح نوعاً من التزييف. لذلك أحاول أن أجعل السياسة خلفيّة طبيعيّة للحكاية، لا لافتة ترفعها الرواية.
الكتابة الأدبيّة بالنسبة لي تقوم على الإنسان أوّلاً: خوفه، ضعفه، رغبته، علاقته بالعنف والسلطة. عندما أبدأ من الإنسان، تتحوّل السياسة تلقائيّاً إلى جزء من النسيج السردي، لا إلى خطاب فوقي أو منشور. بهذا الشكل لا يطغى أحدهما على الآخر؛ الأدب يحافظ على لغته ومزاجه ورموزه، والسياسة تظهر بوصفها قوّة تشكّل الشخصيّات وتترك أثرها على مصائرهم.
أحاول دائمًا حماية الرواية من التحوّل إلى بيان سياسي، وفي الوقت نفسه حماية الحقيقة من الذوبان في المجاز. التوازن يأتي من الانحياز للقصّة أوّلاً، لأنّ القصّة هي التي تمنح النقد السياسي قيمته وعمقه، لا العكس.
-ككاتب من كتاب المنفى، كيف أثّر البعد الجغرافي على رؤيتك للبيئة السوريّة؟ وهل أتاح لك المنفى مسافة نقديّة أوسع أم ألقى عليك عبئاً مضاعفاً في تمثيل ذاكرة المكان؟
المنفى لم يكن مجرّد انتقال جغرافي بالنسبة لي، بل انتقال في زاوية النظر. البعد عن سوريا خلق مفارقة غريبة: المسافة كبّرت الصورة بدل أن تُبعدها. صرت أرى التفاصيل الصغيرة التي كانت تختفي وسط الضجيج اليومي، وصرت أسمع هامش الحياة السوريّة أكثر من صوت مركزها.
إلى حدّ ما، نعم، أعطاني المنفى مسافة نقديّة أوسع. عندما تكون داخل المكان، تكون جزءاً من معاركه ومزاجه وانفعالاته؛ وحين تخرج منه، ترى البنية لا الحادثة، وترى التاريخ لا اللحظة فقط. كأن الغياب يتيح لك أن تضع الذاكرة تحت ضوءٍ مختلف.
لكن مع هذه المسافة تأتي مسؤوليّة مضاعفة. فكاتب المنفى دائماً محكوم بسؤال: هل ما زلت أكتب عن المكان كما هو، أم كما أصبح يسكن داخلي؟ هذا العبء حاضر دائماً، لأنك تدرك أن الذاكرة نفسها قابلة للتآكل، وأن الناس في الداخل يعيشون ما تكتبه بشكل يومي بينما أنت تكتبه من بعيد.
أحاول التعامل مع هذا التوتر بصدق؛ لا أدّعي امتلاك “الصورة الكاملة”، بل أكتب من موقع شاهدٍ خرج جسده وبقيت روحه معلّقة هناك. المنفى منحني وضوحاً، لكنّه حمّلني مسؤوليّة أن أكون أميناً لذاكرة لم تعد ملكي وحدي.
بعد العودة، تغيّر ميزان الأشياء مرّة ثانية. اكتشفت أن البلاد ليست هي الصورة التي حملتها معي، ولا هي النقيض الكامل لها. العودة أعادت لي ملمس الأرض ورائحة الشوارع وصوت الناس، لكنها كشفت أيضاً المسافة التي خلقها المنفى داخلي. كأنني أرى المكان بعيون شخص عاشه وافتقده في الوقت نفسه.
هذا التداخل جعل الكتابة أكثر حذراً وأقرب إلى الإصغاء. لم أعد أكتب من بعيد؛ صرت أكتب من موقعٍ بينيّ، موقع العائد الذي يشعر أنه ضيف في بلده ومقيم في ذاكرته. ومن هذا الموقع تتسع زاوية الرؤية: ترى الخراب والقدرة على النهوض، ترى الألم والقدرة على السخرية منه، وترى الناس كما هم لا كما تتخيلهم.
-في مجموعاتك القصصيّة مثل “عصا غليظة”، اعتمدت أساليب سرد مكثّفة ذات نبرة ساخرة أو تهكميّة. ما الذي تقوله السخرية اليوم في مواجهة واقع بالغ القسوة؟
السخرية بالنسبة لي ليست خفّة، بل طريقة لفهم الثقل. عندما يصبح الواقع قاسياً إلى حدّ يضغط على اللغة نفسها، لا يعود أمام الكاتب سوى خيارين: إمّا أن يستسلم لخطاب مأساوي مباشر يفقد قدرته على النفاذ، أو يجد في السخرية زاوية يُعيد من خلالها ترتيب الفوضى.
السخرية التي أكتب بها ليست ضحكاً على الألم، بل ضحكاً من داخل الألم. هي محاولة لنزع الهيبة الكاذبة عن القمع، وكشف هشاشة ما يبدو صلباً. في مكان مثل سوريا، حيث العنف يصبح يوميّاً لدرجة الاعتياد، تأتي السخرية لتعيد للحدث غرابته، وللظلم فضيحته، وللإنسان هشاشته الطبيعيّة.
هي أيضاً شكل من أشكال النجاة. حين يُسلب من الإنسان كلّ شيء، يبقى له حقّ تحويل تجربته إلى معنى. السخرية تمنحه هذا المعنى، وتمنحه مسافة صغيرة يستطيع أن يتنفس منها، ولو كانت مجرّد “قهقهة” تحت الرماد.
التهكم—في قصص مثل “عصا غليظة”—لا يخفّف القسوة، بل يفضحها. يجعلها مرئيّة، يعرّي آلياتها، ويذكّر القارئ بأن الكارثة لم تعد طبيعية، مهما حاولت السلطة أن تقدّمها كقدر محتوم.
غيث حمّور لـ جدل نيوز: الحقيقة نفسها صارت مجروحة

-تبدو شخصيّات أعمالك غالباً محاصرة بقوى أكبر منها: فساد، سلطة، عطب اجتماعي. هل تهدف إلى تقديم تشريح للإنسان المستلب، أم أنك تعتبر هذه الشخصيّات أدوات لقول شيء أكبر عن البنية السياسيّة نفسها؟
الشخصيّات في رواياتي ليست رموزاً، ولا مجرّد أدوات لشرح فكرة سياسيّة مسبّقة. هي كائنات هشّة، تتكوّن داخل منظومة تضغط عليها من كلّ الجهات: فساد يطوّق الحياة اليوميّة، سلطة تتدخل في تفاصيل النفس، وعطب اجتماعي يجعل الإنسان يشعر أنه يعيش داخل غرفة بلا نوافذ.
حين أكتب عن هؤلاء، لا أهدف إلى تشريح “الإنسان المستلب” كفكرة تجريديّة، بل أرسم حيواته الحقيقيّة—تردده، ضعفه، محاولات نجاته الصغيرة، وانهياراته التي تبدو بسيطة لكنّها في الحقيقة جزء من ماكينة أكبر تعمل على سحقه. من خلال الفرد، يمكن رؤية البنية السياسيّة والاجتماعيّة بطريقة أوضح؛ كأن الإنسان يصبح العدسة التي تكشف ما هو أكبر منه.
بكلام آخر: أنا لا أحمّل الشخصيّات مهمّة تمثيل “خطاب سياسي”، بل أسمح لها بأن تكون مرآة لكيف يتسرّب السياسي إلى تفاصيل الحياة: إلى الحبّ، والخوف، والعمل، وحتّى الصمت. وعندما نرى كيف يتشقق الفرد تحت هذه القوى، نفهم شكل البنية نفسها، ونفهم آليّاتها بعمق أكبر من أيّ خطاب مباشر.
الشخصيّة البشريّة هي نقطة الدخول إلى البنية، لا العكس. ومن خلالها يصبح النقد السياسي ملموساً، مرتبطاً بلحمٍ ودم، لا بشعارات.
-رواية “أبيض قان” تحديداً مسّت غرائز العنف والبراءة معاً. كيف ترى علاقة العنف بالكتابة، وهل يمكن للكاتب أن يعيد تشكيل ذاكرة جماعيّة مجروحة دون إعادة إنتاج الألم؟
في “أبيض قان”، حاولت الاقتراب من العنف ليس بوصفه حدثاً خارجيّاً، بل بوصفه مادّة خام تعيش داخل الإنسان نفسه—جزءاً من هشاشته، ومن حاجته للدفاع عن ذاته، ومن تشوّهات المجتمع التي تتحوّل أحياناً إلى قسوة غير مبررة. العنف في الرواية لم يكن غاية، بل نافذة لطرح سؤال البراءة: كيف يمكن للنفس البشريّة أن تجمع بين النقاء والرغبة في الإيذاء؟ وكيف تنشأ هذه الشروخ في الداخل؟
بالنسبة لي، علاقة الكتابة بالعنف علاقة دقيقة. الكاتب ليس مؤرّخاً للجرح فقط، ولا هو صحفي يصفّ الوقائع. هو شخص يحاول أن يفهم ما وراء الألم، كي لا يتحوّل الألم نفسه إلى مادّة استهلاكيّة. لذلك أحاول تجنّب إعادة إنتاج الصدمة بصورتها الخام؛ أذهب بدلاً من ذلك إلى ما تتركه الصدمة في الداخل: الخوف، الشعور بالذنب، محاولات النجاة، التبرير، الانهيار، ثمّ النهوض.
هل يمكن للكاتب أن يعيد تشكيل الذاكرة الجماعيّة دون أن يكرر الألم؟ أعتقد نعم—إذا كان الانحياز للإنسان لا للمشهد. العنف لا يُروى من أجل الإثارة، بل من أجل الفهم. الذاكرة الجماعيّة المجروحة تحتاج إلى من يضيء ما حول الجرح، لا من يضغط عليه.
الكتابة قادرة على أن تمنح الجرح لغة، وهذه اللغة قد تكون خطوة أولى في تحويل الذاكرة من لعنة إلى وعي.
-يميل كثير من كتّاب المنفى إلى النوستالجيا، لكن في أعمالك نجد نقداً للماضي والحاضر معاً. هل تحاول مقاومة الحنين كآليّة دفاعيّة؟ وكيف تحافظ على مسافة من خطاب الضحيّة؟
الحنين بالنسبة لكثير من كتّاب المنفى يتحوّل إلى ملجأ، لكن بالنسبة لي كان دائماً سؤالاً مريباً. الحنين قد يبدو عاطفة نبيلة، لكنّه في العمق قد يصبح طريقة لتهذيب الذاكرة وتجميل الماضي بحيث يفقد القارئ القدرة على رؤية الحقيقة. لذلك أحاول مقاومة الحنين ليس لأنني أرفضه، بل لأنني أخشى من قدرته على تضليل السرد.
الماضي السوري لم يكن جنّة ضائعة، والحاضر ليس جحيماً كاملاً. كلاهما مليء بالتعقيدات والأخطاء والانكسارات. الكتابة بالنسبة لي ليست دعوة للعودة إلى “ما كان”، ولا دعوة للقطع الكامل معه؛ هي محاولة لوضع الماضي والحاضر على الطاولة نفسها، تحت الضوء نفسه، دون تجميل ودون انتقام.
أمّا خطاب الضحيّة، فأحاول الحفاظ على مسافة منه لأنني أؤمن بأن الإنسان أكثر تعقيداً من أن يُختزل في موقع واحد. الضحيّة قد تكون متواطئة أحياناً، والجاني قد يكون منهاراً من الداخل. الرواية تتسع لهذه التناقضات، ولا تحتاج إلى تثبيت هوية نهائيّة لأيّ شخصيّة.
حين أكتب، أحاول أن أنقل التجربة بحقيقتها الإنسانيّة لا بمظلوميّتها فقط. الصوت الذي يتحدّث في الرواية ليس صوت “ضحيّة تطلب التعاطف”، بل صوت شخص يحاول أن يفهم ما حدث له وما حدث لبلاده، حتّى عندما يكون هذا الفهم مؤلماً.
هكذا تبقى الكتابة مساحة للوعي، لا للشفقة؛ للمعنى، لا للتهويم.
وكلّما قاومت الحنين، اقتربت أكثر من الحقيقة، وكلّما ابتعدت عن خطاب الضحيّة، اقتربت من الإنسان نفسه—بكلّ تناقضاته التي تمنح الأدب نبضه.
–في “غراب” و”إمبراطورية” يظهر اهتمامك بالبنى الخفيّة التي تحرّك المجتمع: السلطة، الخوف، الرموز، الأساطير. كيف تختار نظام الإشارات الذي تبني عليه عالمك الروائي؟
أنا لا أبدأ من الرمز بحدّ ذاته، بل من السؤال الذي أريد للرواية أن تطرحه. كلّ رواية تحتاج إلى “قاموس خفي” كي تتحرّك داخله الشخصيّات والأحداث. في “غراب” و”إمبراطورية”، الأسطورة والسلطة والخوف ليست إضافات جماليّة، بل هي طبقات واقعيّة—موروثة ومُصنَّعة—تؤثّر في السلوك اليومي للناس دون أن ينتبهوا لها.
لذلك، حين أختار نظام الإشارات الذي سيبني العالم الروائي، أبدأ بالسماع قبل الكتابة: ما الذي تخشاه الشخصية؟ ما الذي تورثه الأجيال بلا وعي؟ ما الذي تكرّسه السلطة حتّى يصبح جزءاً من المخيّلة العامّة؟ هذه الأسئلة هي التي تعطيني المفتاح الرمزي، وليس العكس.
الإشارة في الرواية عندي تعمل مثل “محرّك صامت” تفسّر ما لا يُقال، وتربط بين الفرد والبنية من دون خطاب مباشر. الرموز تأتي من ذاكرة المكان، من الميثولوجيا الشعبيّة، ومن اللغة اليوميّة التي تصنعها السلّطة. بعضها أخلقه، وبعضها أستعيره وأعيد صياغته، وبعضها يظهر مجرّد ظلّ لا يكتمل إلا في ذهن القارئ.
الأهمّ أنّ الإشارة لا تكون أبداً لافتة كبيرة، بل خيطاً رفيعاً يمرّ في السرد: غرابٌ يغيّر المعنى بحسب من يراه، أو شعارٌ سلطوي يتحوّل إلى طقس، أو حمار يخرج من الهامش ليحتلّ مركز الحكاية.
المقياس الوحيد عندي هو: هل هذا الرمز يضيء الإنسان، أم يحجبه؟ هل يكشف بنية الخوف، أم يصبح جزءاً منها؟ إذا ساعد الرمز على فهم العالم، يبقى؛ وإذا صار عبئاً يعيق القصّة، أتخلّى عنه.
الكاتب والروائي غيث حمّور
-من خلال تجربتك، ما التحدّي الأكبر اليوم أمام الكاتب السوري: أن يقول الحقيقة، أم أن يجد قارئاً قادراً على استقبالها، أم أن يصوغ لغة جديدة تليق بمرحلة ما بعد الانهيار؟
التحدّي الأكبر ليس واحداً منها فقط، بل هذا الثالوث كلّه. الكاتب السوري اليوم يقف في منطقة رماديّة: يريد أن يقول الحقيقة، لكنّه يدرك أن الحقيقة نفسها صارت مجروحة، محمولة بدماء وذكريات وانهيارات. ويريد قارئاً مستعداً لاستقبال ما يُكتب، لكن القارئ هو الآخر خرج من حرب طويلة، ومثله مثل الكاتب يبحث عن لغة تشبهه ولا تزيد عليه الألم.
أمّا اللغة … فهي ربّما أصعب الامتحانات. لا يمكن استخدام اللغة القديمة لوصف عالم تحطّم؛ ولا يمكن الاكتفاء بلغة سياسيّة جاهزة، ولا بلغة شاعريّة تحاول أن تضع الغبار في علبة. نحن نعيش مرحلة تحتاج إلى لغة تلتقط الواقع من دون أن تتواطأ معه، وتنحاز للإنسان من دون أن تزيّف تجربته.
إذا كان عليّ أن أختصر، أقول إن التحدّي الحقيقي هو: كيف تكتب من قلب الانهيار، لا من فوقه؟
كيف تقول الحقيقة دون أن تتحوّل إلى شاهد طبّي، ودون أن تجرح من عاشها؟
كيف تبحث عن قارئٍ لم يعد يثق بالكلمات، ثمّ تقنعه أن اللغة ما زالت قادرة على أن تنقله إلى مكان آخر؟
الكتابة السوريّة اليوم ليست تمريناً فنّيّاً، بل محاولة مستمرة لخلق معنى في مكان تمّ تجريفه من المعنى. لذلك أرى أن مهمّة الكاتب هي الجمع بين هذه التحدّيات الثلاثة: أن يقول الحقيقة، وأن يجد قارئاً يستقبلها، وأن يخترع لغة تُداوي قليلاً دون أن تُخدّر.